 |
 |
 |
|
|
|
|
||||||||
 |
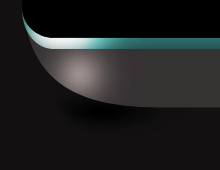 |
| …»●[دواويــن الشعــراء والشاعرات المقرؤهـ المسموعهــ]●«… { .. كل ماهو جديد للشعراء والشاعرات من مقروء و مسموع وتمنع الردود .. } |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
 |
 |
 |
|
|
|
|
||||||||
 |
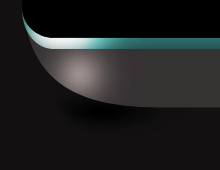 |
| …»●[دواويــن الشعــراء والشاعرات المقرؤهـ المسموعهــ]●«… { .. كل ماهو جديد للشعراء والشاعرات من مقروء و مسموع وتمنع الردود .. } |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
#14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
|
وبهذا يصبح من اللغو قول سارتر :"ولن يكون هذا الكوخ رمزاً للبؤس، لأنه لكي يكون رمزاً يجب أن يكون علامة لها مدلولها في حين هو في الواقع شيء من الأشياء".
قال أبو عبدالرحمن: هو ذو مفهوم وكفى ، وهو شيء من الأشياء بالنسبة للأصباغ واللوحة وكونه صورة على مثال. وهو ذو مفهوم لكونه رمزاً لمجتمع ما، فهو صورة محلٍّ لصورة حالٍّ. وإذا كان سارتر يعلل عدم قابلية الفن للالتزام بضعف تأثره- بناء على مقارنته فنون الرسامين بلوحة الولد المضياع-: فلا يغيبن عن البال أن الفنون أعظم تأثيراً من النثر القابل للالتزام عند سارتر المشروط بخفاء الحلية الفنية. وليلاحظ أيضاً أن مقارنته إنما كانت بين فنون جميلة وليست مقارنة بين ما يقبل الالتزام وما لا يقبله. والفنون بدأت أول ما بدأت لتكون تعبيراً، وإنما جاءت محضية الفن في لحظات فراغ وترف، فبطل بذلك قوله: فالمعاني لا تُرسم، ولا توضع في ألحان؟. وجمهور العقلاء وذوي الاختصاص هم الذين يجرؤون على تطويع الفن للالتزام، لأن القيمة التعبيرية أم القيم الجمالية. ولو فرض أن الإعراب عن المعاني هو ميزة الكاتب التي لا يشاركه فيها غيره لما كان ذلك مخصصاً له بقابلية الالتزام، لأن الالتزام ارتباط بقضية وليس هو صفة من صفات التعبير، بل أي صفة من صفات التعبير تقبل الارتباط بقضية. ونجد المَطالب التعبيرية في فن السينما، ففي الثلث الأول من القرن العشرين نودي بأن تكون السينما الفن السابع.. وهذا النداء جاء رغم علمهم المسبق بأن السينما ألصق بالفنون التشكيلية، لأن أكثر عناصرها الشكل واللون والصورة، وحققت التجربات السينمائية قبولها للتمذهب الأدبي والفني، فعلى سبيل المثال تعتبر التجريدية من مذاهب الأدب والفن، ولكن السينما غير خالصة للتجريد، وإلا لكانت مجرد أفلام كرتونية أو مصور متحركة. بل النص الأدبي عنصر أساس في السينما، ولكن الصورة واللون والشكل كل ذلك يأتي بالتبع، وهو من إبداع المخرج، ليظهر مدلول النص بتعبير سينمائي.. أي بتركيب صور لو استطاعت الكلمة التعبير عنها لكان التعبير بالصورة المثل الأعلى للمتعة والبراعة. إن في أجهزة التصوير السينمائي ما يسمى السكوب والتكنيسكوب اللذين يكثفان عرض صور الأشياء ثم يعيدانها إلى حجمها الواقعي. وهناك جهاز الزوم الذي يقرب مسافات الرؤية للصور المتباعدة. وبهذا يصح أن السينما تحقق قيماً تعبيرية لا تتوفر في الفنون الجميلة الأخرى. وهذه الأجهزة السينمائية مع أجهزة غيرها تيسِّر (39) للمخرج عملاً إبداعياً متميزاً حينما يستطيع رسم ما لا يستطاع تصويره من الأخيلة والأفكار التي يجيش بها خاطر الفنان كاتب النص أو خاطر السينمائي المخرج. ولهذا كان مصور السينما شريك المخرج وكاتب النص في بلورة الفن السينمائي، ومن ثم يكون الفيلم حضوراً حسياً وتكثيفاً تعبيرياً بمختلف وسائل التعبير. ويتفاعل المشاهد مع الفيلم بتناغم حواسه وملكات فهمه ومقومات وعيه فيخرج بوعي أعمق من الانطباع الحسي والفهم الفكري. ويسمو هذا الوعي ويتكثف حينما يكون الجمهور نموذجاً فريداً في ثقافته وفنه، وذلك حينما يدرك مدى قبول التعبير السينمائي للتمذهب لبفني على نجو التمذهب في الأدب والفنون الأخرى. وقبول التعبير السينمائي للتمذهب من الأبجديات في تجربة المختصين.. بيد أن المشاهد الشرقي- وبالأخص العربي- غير مستعد ثقافياً للاستمتاع بمشاهد تنطوي على غيبيات الرموز التي يتمذهب لها الفن التشكيلي مثلاً. إن المخرج قد يصور طائراً على غصن يقابله صوره فم ليجرد معنى الغناء. ولكن الشرقي لا ينسجم كثيراً مع هذه الدلالة، لأنه يرهن متعته بفهم المدلول الرمزي الذي قد يتأخر بحكم تعاقب المشاهد ديناميكياً. وكذلك قصية الشكل والمضمون والمدلول حسب مطالب الجمال والفكر فإنها تنقسم إلى مذاهب حسب الاكتفاء بأحد تلك العناصر في الاعتبار أو تغليبها. إن الشكل هو المنبَثق لمتعة المشاهد الشرقي، وكذلك المضمون إذا كان سريع الإفهام في أجزاء المشْهّدِ المتعاقبة، لأن المشاهد يتشوق إلى حل العقدة. لهذا أقول: إن السينما التي تلح على تمذهب فني في تعبير الصورة واللون والشكل: لا أتوقع لها نجاحاً سريعاً في شرقنا العربي، لأنها تعلق المشاهد في تحفز يتأزم لتفكير لم تتهيأ له ظروفه الثقافية. فحينما يرى المشاهد العربي ممثلاً يسير بصمت في شارع طويل غير مطروق ربما لا يهتدي تفكيره إلى المدلول بسرعة تناسب تعاقب المشهد، وربما اضطر إلى قطع تفكيره منذ مفاجأته بمشهد آخر، وربما واصل تفكيره ففاته مدلول المشهد الثاني. وكل هذا لا يناسب الشرقي، (40) لأنه يريد أن يستمتع بفهم سريع يمكنه من المتابعة، ولا يستطيع رهن متعته بإحساس جمالي متوقف على تكفير متأزم.. وقد يفلس من الفهم فيكون إحساسه بالجمال سطحياً. والعربي أمام لوحة تشكيلية ثابته يستطيع أن يهتدي بعد عشرات أو مئات التأملات إلى مدلول اللوحة، لأنه ليس هناك مشاهد متعاقبة تستفذه. ولا يهديه إلى فهم سريع أن يكَّون ثقافة تشكيلية كأن يعرف بأن اللون الأحمر يدل على الوحشية أو النشاط، وأن اللون الأزرق يدل على الهدوء والعاطفة، وأن اللون البني يدل على الحزر والتوقع. وذلك أن دلالة الألوان غير ثابتة وهي في جدلية العلاقات التي يبتكرها الفنان. ويميز الفن السينمائي عن فني التصوير والنحت أنه يحرك الأشكال والألوان.. وفي هذا إثراء للوعي وتعميق لإحساس حاسة البصر. ويتوسل الفن السينمائي بخداع البصر فيضيف قيماً تعبيرية جديدة. ودرج الذوق الشرقي على أن يطلب في الفيلم حبكة وعقدة مثيرة يستمتع أو يعتبر بحلها. ولكن فن القصة وأخواتها حنك الذوق العربي، فلم يسلبه العقدة تارة، وتارة جعلها نتيجة يحسها المشاهد في وعيه كأن يشاهد أحداث بطل يتحدى الصعاب وحده، ويناضل كل مظهر متصلب يتحدى طموحه، أو مظهر منوم يسلب طموحه.. ثم تنتهي حياة البطل بالعمدية أو الفشل دون عون من المجتمع الذي ناضل البطل من أجله، أو إحساس منه بفادحة الخطب.. فليس هاهنا عقدة، ولكن المشاهد يستنبطها من وعيه، وهي أن البطولة الفردية لا تجدي. وهذا نوع من الفهم السريع لا ينغص على الشرقي متعته. وإذا اعتبرنا السينما لغة التعبير- وهو اعتبار صحيح- فإننا نجد ضروب التعبير الأخرى لا تستحضر كل منافذ الحس. فأنت تسمع كلام محدثك فلا تحتاج إلا إلى إصغاء السمع لتستوعب الحروف. وقد تعتصر ذاكرتك في النادر إذا غاب عنك المعنى المعجمي، وبمجرد علمك بمعناه تحضر صورة المراد في ذهنك، لأن اللغة رمز لما هو في ذهنك.. إلا أن هذا الوعي نتيجة إحساس واحد حاصل من حاسة السمع. وقل مثل ذلك فيما تراه فتقرؤه كالحروف، أو تراه فتفهمه كاللوحات التشكيلية، أو ما تراه وتسمعه معاً كحركات الرقص. أما السينما فهي الشكل الأكمل لضروب العبير، لأنها تجمع بين وسائل الحس وملكات الفهم، وتجمع بين ضروب التعبير، وبهذا تكون السينما وعياً إنسانياً أكمل. إن الكاميرا في السينما التي اعتبرها الكسندر استروك قلماً تنقل القضية زماناً ومكاناً.. إنها زمكانية التعبير.. فهذا أحفل من نوعية التعبير التي لا تستجمع الحس والوعي. والكاميرا لا تنقل أي زمان ومكان، بل تنقل وفق علاقات جدلية يفقهها المشاهد بفكره ووعيه. وفي السينما حوار وغناء ولون وشكل.. أي تكثيف يصطفي القيم التعبيرية للصوت والصورة والرمز الذي هو علاقة بين صوت وصورة، وبين صورة وصوت، وبين صوت وصورة.. والمشاهد حينئذ يجمع معاني، ويستنبط أفكاراً بأكثر من ضرب تعبيري بتناغم مشترك، وبهذا يكون نص الفيلم المكتوب والسيناريو المكتوب مادة خاماً بدائية للعمل السينمائي وإن كان قمة العمل الأدبي.. وكان قمة لما كان المجال مجال التعبير اللغويس والأدبي فحسب. ولكنه أصبح ثانوياً في السينما، لأن التعبير اللغوي والأدبي أحد عناصر السينما وليس جميعها. وإذ صحت هذه الحقيقة أصبح من البهي أنه ليس من أخص خصائص المخرج أن يطوع إمكانات التكنولوجيا لنقل المشهد الذي اقترحه كاتب النص بقياس زمني وكمي محدد حينما يقبع في غرفة المراقبة والإنذار.. ليس عمل المخرج عملاً حِرَفياً - بكسر الحاء وفتح الراء- يتدرب عليه ويطبقه كما أتاحت له الممارسة. إن من صميم عمله ابتكار ضروب التعبير السينمائية التي تُطوَّع لها إمكانات الممارسة والحرفة. من واجب المخرج أن يكون فناناً بطبعه، ويكون تطويع إمكانات التكنولوجيا من وسائله.. يكون ذا خبرة بالنظريات الأدبية والفنية والجمالية. ولعله من المبالغة الآخذة بأبعد الطرفين ما دعا إليه أصحاب نظرية (الفيلم النقي)، وهو أن يكون الفيلم نصاً أدبياً مكتوباً، بل مادة مسجلة مباشرة. أي أن يقوم المخرج مقام كاتب النص، فيسجل العمل بآلته. وهذا المذهب يحدُّ من تقنية العمل الفني، ويدعو إلى ارتجال البداية. ولهذا أرى هذا المذهب غلواً يُطامِن من عظمة الفن ويشوه محياه. والطرف الذميم الآخر أن يكون المخرج في حضانة كاتب النص يقتصر على تصوير الأماكن والديكورات، أو يتعسف في استعمال سلطة المهنة فيشاغب كاتب النص بما يعاكس هدفه وتقنيته الفنية بتضخيم الصور أو صخب الأصوات أو التصرف في اللهجة أو عكس ذلك من وسائل التزييف البصري والسمعي.. مما يجعل العمل الفني مبالغاً فيه دون مسوغ فكري مقبول. إن كتابة النص بلغة أدبية- بغض النظر عن نوع اللغة من عربية أو محلية- شرط أساسي فيما أرى. وإذا لم يكن المخرج هو كاتب النص فلابد أن يكون على مستوى يؤهله لمشاركة كاتب النص في فهم عمله الإبداعي برؤيا فنية ورؤية نظرية. وإنما يشارك الكاتب مشاركة فعالة عند تحويل النص من القراءة إلى المشاهدة.. على أن لا يحيف على أهدافه وتقنيته إذا كان النص قائماً بشرطه الأدبي والفني، بل يوفق بين ضروب التعبير في المشاهد، فيأخذ من دلالة الصورة أو الرمز ما يحد من دلالة اللغة والإسهاب في عمل الأديب. إن المخرج مشارك فعال في لغة الفيلم الأدبية، وإن المخرج مطلوب منه إبداع مستقل في المادة المصورة، وبهذا يكون مخرجاً حقيقة لا مجرد منفذ. وإننا إذا نظرنا إلى مادة الفيلم نظرة أدبية مستقلة قبل أن تكون فيلماًفإنما ننظر بمقاييس الأدب. فإذا أصبح فيلماً صرنا ننظر إليه بخصائص العمل الفني السينمائي، وهي أعم من خصائص العمل الأدبي. ويزعم كثيرون من المعاصرين أن مفهوم الحداثة في الإبداع الفني لا يعني مجرد التسلية أو الدرس الأخلاقي، وإنما مفهوم الحداثة أن يكون العمل الفني كتلة موحدة تثير.. إلا أنه من اللازم معرفة حقيقة التأثير لذلك التوتر الداخلي الذي يحدث تأثيراً حسياً وفكرياً. إن هذا التأثير لا يخلو من أن يكون مجرد متعة أو طقساً أو درساً أو هُنَّ مجتمعات. إذن تلك العبارة تكييف يميز فنية العمل، ولا تطلُّعَ لفنية العمل من غير طَرْق باب النظرية الجمالية. وكيف يكون العمل الفني إن لم يكن إثارة بقيم دينية أو فكرية أو خلقية أو جمالية.. إن لم يكن أرقى وسيلة للتوجية أو التثقيف أو المتعة بالطرافة والجمال والإبداع. إن اصطياد العنقاء أسهل من ابتغاء عمل فني لا تكون إثارته بغير هذه الحقول. إن الجمالية مطلب أساس في السينما، بل هي شرطها، لأن السينما تعبير ووعي بتوسلات جمالية. وإنما المحذور أن تكون تسلية فحسب، أو أن يكون الهدف فيها ضئيلاً غامضاً. إن الجمالية شرط أساس لهوية السينما، وشرطها الالتزامي أن تكون ذات أهمية دينية أو اجتماعية أو سياسية أو فكرية أو تثقيفية. أما السينما الخالصة للمتعة والتسلية فإنها توسِّع دائرة الفراغ في حياة الجمهور، وتبعد المتحصص عن مجالة أكثر من خطوة. والسينما أبلغ من خطابة المذيع وتزويق الصحفي، لأنها تحشد البعد الزمني للمتغيرات في تعاقب مكاني أمام المشاهد. وفي السينما ميزتان: ميزة الرؤية الفنية، وميزة التعبير. فميزة الرؤية بوسائل فكرية وفلسفية، وميزة التعبير بإحساس جمالي. وميزة التعبير خالصة لقيمة الجمال، وميزة الرؤية مشروطة بعنصر جمالي. ولا ريب أن السينما وسيلة فنية لتكوين جمهور يقبل الالتزام بسحر الفن وتحت تأثيره إذا كان الفيلم ملتزماً.. والوجه في ذلك أنها تربي ذوق المتفرج فلا تقبل التوافه في حياته، كما تمهد للإبداع الذكي فتتيح للموهبة ممارسة إبداع رائع. ولهذا كان شعار جورج سادل: أن ترتبط السينما بواقع الأمة وفعالية الشعب. وإنما جاءت العقيدة بأن السينما وسيلة تسلية من ظرف نشأتها، فقد كانت عوضاً عن وسائل ترفيهية كالمقاهي والملاهي وألعاب الشطرنج والضومنة والورقة، إلا أن هذا لا يعني أن السينما مشروطة بظرف نشأتها، لاسيما أن هذا الظرف وجد عند العرب فحسب. أما السينما في حقيقة نشأتها فقد كانت مرتبطة بقيم الفن والأدب، فهي مسرحية مسجلة، وهي لغة تشكيلية لبعض مدلولات النص المسرحي، وهي تتمذهب بالمذاهب الأدبية والفنية، فلها ما للأدب والفن، وعليها ما عليها. وقد يرسم الفنان قلباً تندلع منه النيران وبجانبه رسم ليراع، فتأخذ من ذلك تجريداً لمدلول رومانسي. ومثل ذلك ما فقهه المتحاكون من تمثال ملك الفراعنة (خفرع) لأنهم رأوا عينية مفتوحتين ممتدتين، ففهموا من ذلك أن نظراتهما تمتدان وراء كل ما هو فان كما لو كانتا موجهتين نحو الخلود. قال أبو عبدالرحمن: قد يكون ناحت التمثال قاصداً لذلك، وقد يكون حاكياً للواقع دون تجريد، لأن روح الميت تشخيص في المشاهدة البشرية الدائمة. إنني لا أنكر التجريد في الفن، وإنما أقول: إن المستبعد واقعاً المستكره تصوراً أن تكون الزخارف والرسوم في تاريخ العرب والمسلمين تحمل مدلولاً رمزياً تجريدياً.. من أن كتَّاب مجلة المعرفة السورية حاولوا أن يصبغوها بصبغة المذهب التجريدي (41). فمحيي الدين صبحي في افتتاحيته يرى أن الفن العربي نزوع إلى المطلق، لأن الأشكال الهندسية المجردة أو الأغصان المتكررة ليست شيئاً سوى تعبير الإنسان العربي عن إحساسه بالأبدية المجردة، وبالعودة الأبدية التي تميز حياة الطبيعة، وبالإيقاع المتكرر والمتجدد أباً للحياة السرمدية بلا ابتداء ولا انتهاء. وتأتي كاتبة اسمها (انجي أفلاطون) فتشرح لنا الفن العربي من خلال شرحها لعقيدتنا، فتقول :"وجاء الإسلام ديناً قوياً عملاقاً بلغتْ بفلسفة الوحدانية فيه كمالها وتمامها، ووضعت الخالق والمخلوق في مكان فريد لم يسبقها إليه أي فلسفة أخرى، وتجسدت فكرة التجريد في نمط عبقري، فالخالق سبحانه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. هي إذن فلسفة التصوف والفناء في المطلق.. فلسفة النظام والتنظيم المحكم. وبديهي أن يكون لهذه الفلسفة وهذا الفكر فن ذو خصائص مميزة، وكانت هذه الخصائص بالفعل هي التجريد بناء على الصقل والتنظيم". وتابع أفكارها بأسلوب إنشائي الدكتور رضا بمقالة عنوانها (التجريدية في الفن الإسلامي)، وزعم أن عقيدة الإسلام في ذاتها فكر موجود. وقال طارق شريف :"فالزخرفة العربية تسعى للتأكيد على ما هو مطلق عن طريق تكرار شكل نسبي حسي، وهي علاقات خطية محيرة بتداخلها تدلنا على السرمدي اللامتناهي". قال أبو عبدالرحمن: الدافع لهؤلاء في كل ما كتبوه- على افتراض حسن النية- هو تأكيد الذات العربية التاريخية في مجال الفن التشكيلي. وباستثناء الشعور بدلالة الألوان فإن الزخرف العربي والرسم العربي لا يعني شيئاً ألبتة سوى جمال المنظر.. وقد أدركت في قريتي مزخرفي البناء بوضع الشرفات والأصباغ والخطوط لا يملكون أي دلالة سوى التجميل جرياً على ألسنة الأسلاف، ولو كان لهم هدف تجريدي لكانت لهم نظرية مكتوبة. والظاهر- والله اعلم- أن الهدف لهذه المباحث جعل النظير الفني وسيلة للتبشير أو التشكيك، لأنهم أقحموا ذلك في جوهر العقيدة.. إنها علمانية يطفح بها الإناء. والعقيدة الإسلامية أبعد ما تكون عن التجريد، لأنها لم تكتف بأدوات النفي في سورة الإخلاص، بل نصوص الإثبات أكثر.. بل أثبتت سورة الإخلاص أنه أحد صمد. إن العقيدة تشجب التعطيل لأنه تجريد كافر، وتنفي التشبيه والتمثيل لأنه إثبات لغبر المراد. وإنما التجريد عند من يجعل الأب والابن وروح القدس إلاهاً واحداً!!. ويجعل هذه الخرافة أمانة لا يحل تفسيرها.. ولست أدري من أين فهمت انجي أفلاطون دعوى التصوف والفناء في المطلق، وأنالخالق والمخلوق كل في مكان فريد؟!. من أين فهمت واجدية الوجود من سورة الإخلاص ؟. إن السورة الكريمة بينت أن الخالق أحد، وليس المخلوق كذلك.. وأن الخالق لم يلد ولم يولد لأن المخلوق يلد ويولد، وأن الخالق ليس له كفؤ، لأن المخلوق له أكفاء. وبإيجاز شديد فإن خمول موهبتنا في فرع فني أو رغبتنا عنه لن يصيبها بمكروه أعظم وأفدح من التلاعب بعقيدتها. ولقد اقتطع سارتر الشعر من فن الكلام وألحقه بالفنون الجميلة التي لا تقبل الالتزام أو أن تكون فن مواقف، وقد أطال سارتر النفس في هذا بتحليل رائع وممتع، ولكنه غير مؤثر في الحكم. لقد أوضح الفروق بين الفنون الجميلة كالأصوات والألوان وبين الكلام، ثم أوضح الفروق بين النثر والشعر. ولكن هذه الفروق- على روعتها- غير مؤثرة في نظرية الالتزام.. أي أنها فروق غير معتبرة في الحكم. ومن الفروق التي ذكرها سارتر بين الشعر والنثر: أن الناثر يستخدم الكلمة، أما الشاعر فيخدمها.. أي أن لغة الشاعر غاية، ولغة الناثر وسيلة إلى غاية.. أو أن الكلمة عند الشاعر شيء بينما هي عند الناثر دلالة على شيء. ويشرح سارتر هذه الظاهرة الفارقة بقوله: النثر لحظة خاصة من لحظات العمل. وهو يرى أن التأمل في الكلمات من عمل الشاعر وحده.. أما الناثر فليس من غايته التأمل البحت. إن التأمل والنظر العقلي ميدانها الصمت، وغاية اللغة الاتصال بالآخرين والإفضاء إليهم.. إذن ليس من المعتبر في الكلمة أن تكون تروق في ذاتها أو لا تروق، وإنما المعتبر أن تكون تدل على دلالة صحيحة أو واضحة على بعض الأشياء أو بعض المبادئ. ونتيجة لذلك نكون على ذكر من فكرة من الأفكار التي عَّلمنا إياها بعض الناس عن طريق الكلمات دون أن نستطيع ذكر كلمة واحدة من الكلمات التي تعلمنا الفكرة بواسطتها. إذن اللغة مجرد وظيفة (وسيلة)، ولهذا يصف هدف الناثر بقوة التعبير.. أي الدلالة على قصده. قال أبو عبدالرحمن : هذا موجز كلام سارتر بتصرف واختصار وتقديم وتأخير لم يُخلَّ بشيء من مراده، وإنما أردت التبسيط وتذليل الفكر للقارئ . إن ما ذكره سارتر من فرق ليس دائماً من الناحية الوجودية، وليس معتبراً من الناحية الحكمية.. فخدمة الكلمة ليست من خصيصة الشاعر لأن الناثر الفني يخدم كلمته قبل أن يستخدمها. وكون الشاعر أو الناثر الفني يخدم الكلمة: لا يعني أنه لا يستخدمها، ولا يعني أن الكلمة التي جعلها غاية ليست وسيلة لغاية أخرى.. فالثالث غير مرفوع هاهنا.. أعني أن القسمة غير محصورة في ثنائية الوسيلة والغاية، بل هناك قسم ثالث، وهو أن يكون الشيء غاية في ذاته وسيلة لغيره. من المقطوع به أن الشعر- والنثر الفني أيضاًَ- تكون اللغة فيه غاية في ذاتها وليست وسيلة لغاية أخرى كما نجد عند الأسلوبيين وأصحاب محضية الفن، ولكن ليس معنى ذلك أن الشعر والنثر الفني لا يكونان إلا كذلك حتى ندعي أنهما غير قابلين للالتزام، بل يكون للشاعر والناثر الفني موقف يلتزم به، ولكنه لا يتوسل إلى التعبير عن موقفه بلغة عادية مباشرة، وإنما يتخذ فنية التعبير غاية له، وتكون هذه الغاية في النهاية وسيلة للتعبير عن موقفه!. إن الشاعر الملتزم، والناثر الفني الملتزم يخدمان كلمتيهما ليستخدماها!. وقول سارتر :"الكلمة عند الشاعر شيء بينما هي عند الناثر دلالة على شيء": حكم يصدق فقط على الأسلوبين وأصحاب محضية الفن.. أما الشاعر فالكلمة عنده شيء ودلالة على شيء في آن واحد!. هي عنده شيء لأن فنية الكلمة غاية إحساسه الجمالي، وهي عنده دلالة على شيء لأنها تعبر عن موقف أو توحي به!. إن الكلمة العادية في الغالب تكون أوضح بالمقصود وأسرع إليه، أما الكلمة الفنية فقد تكون أوضح وأسرع من الكلمة العادية ولكنها في الغالب لا تدل على المقصود إلا بغموض وبُعد يجليه ويسرع به كشف المتلقي الموهوب. ولهذا فالكلمة الفنية أرقى وسائل التعبير عن المواقف، لأنها اتخذت غاية لتكون وسيلة للمضمون الأيدلوجي. والتأمل في الكلمة لتكون تعبيراً فنياً لا يعني أن الكلمة ليست لحظة عمل . وذلك أن الشاعر الملتزم تدفعه لحظة العمل إلى التأمل في الكلمة ليعبر عن مراده بإيحاء فني، والشاعر الملتزم مبيِّت موقفه ليكشف عنه بفنية تقتضي التأمل في الكلمة. ولا ريب أن التأمل والنظر العقلي ميدانهما الصمت المطلق، ولكن بعد لحظة الصمت يكون التعبير إما تلقائياً بلغة عادية، وإما فنياً بلغة احتاجت إلى لحظات أخرى من الصمت للتأمل والنظر العقلي. وقد تكون اللغة الفنية تلقائية أيضاً . وغاية اللغة عند الناثر والشاعر الاتصال بالآخرين والإفضاء إليهم ما ظل للمتكلم موقف يعبر عنه، وما ظل قُلبَّا لا موقف له، وما ظلَّ مثرثراً. فالاتصال والإفضاء معنيان لا أثر لهما في نظرية الالتزام، وإنما يتجدد الالتزام بنوعية الاتصال والإفضاء مضموناً لا وسيلة.. أما الوسيلة فقد تكون عادية، وقد تكون فنية. ونظرية الالتزام لا تتحدد بكون الكلمة تروق في ذاتها، أو بكونها ذات مدلول واضح. إنما تتحدد نظرية الالتزام بصحة دلالة الكلمة على الموقف سواء أكانت إيحائية أم مباشرة. وإنما يكون الالتزام فنياً حينما تكون الكلمة تروق في ذاتها. إن الشاعر الملتزم يخلص في اتخاذ الكلمة غاية يخدمهما بمطلب الإحساس الجمالي، ولكنه مصمم على أن يكون ذلك الإحساس مثيراً أو غارساً لموقف في العقل والعاطفة. وليست الكلمة الفنية أقدر على البرهنة على الموقف، ولكنها تقنع به بسحر الفن، فإن قدرت على البرهنة عليه فهي أبلغ أثراً من اللغة العلمية المجردة. فكوننا نذكر أو نتمثل الفكرة وننسى الكلمات التي عبرت عنها لا يعني أن الشعر غير قابل للالتزام، وإنما يعني أن الموقف قد يُحفظ وتَنسى الذاكرةُ اللغة الفنية التي عبرت عنه.. ونسيان فنية التعبير قضية قابلية الفن للالتزام. ولا ضير على سارتر إذا جعل "قوة التعبير" تعريفاً لما حقق "قصد المتكلم" فلا مشاحة في الاصطلاح في الاصطلاح. وإنما قوة التعبير التي عناها سارتر قد تكون عادية، وقد تكون ممتعة لأنها فنية، وهذا يعني قابلية الفن للالتزام. والجمال الغاية لا دلالة تعبيرية كما أن للكلمة معنى غير فكر الكلمة. يقول هيجل :"يبدو الاسم غير جوهري بالقياس إلى مدلوله الذي هو جوهري". وهذا المعنى جعله سارتر تكأة له ليبرهن على أن الشعر غير قابل للالتزام، وأن الالتزام للكاتب، لأن عمل الكاتب الإعراب عن المعاني، وميدان المعاني إنما هو النثر، أما الشعراء فيترفعون باللغة عن أن تكون نفعية.. ويريد سارتر بالنفعية الدلالة العرفية المباشرة. يقول سارتر :"وحيث إن البحث عن الحقيقة لا يتم إلا بواسطة اللغة واستخدامها أداة فليس لنا إذن أن نتصور أن هدف الشعراء هو استطلاع الحقائق أو عرضها. وهم لا يفكرون كذلك في الدلالة على العالم وما فيه، وبالتالي لا يرمون إلى تسمية المعاني بالألفاظ، لأن التسمية تتطلب تضحية تامة بالاسم في سبيل المسمى". قال أبو عبدالرحمن: هذا معنى كرره سارتر كثيراً، وعادته أن يعيد نفس المعنى بألفاظ مختلفة. ولقد أخطأ سارتر في قصره الإعراب عن المعاني على الكاتب وحده، وأخطأ في جعله النثر ميدان المعاني وحده.. بل كل من تكلم عن مراده، وكل من يعني شيئاً ويتخذ الكلام وسيلته: فلابد أن يكون كلامه إعراباً عن المعنى .. إلا أن الإعراب عن المعاني يكون بكلمة قاموسية مباشرة، ويكون بإيحاءات لفظية أو جمالية تنطبع في الشعور فيفهمها العقل، أو يستنبطها الفكر من وسائل مادية موضوعية. والإيحاء - وهو إعراب عن معنى- طريقة الشاعر والناثر معاً. قال سارتر :"فليس الشعراء بمتكلمين ولا صامتين، بل لهم شأن آخر، وقد قيل عنهم: أنهم يريدون القضاء على سلامة القول بمزاوجات وحشية بين الألفاظ. وهذا خطأ، لأنه يلزم لذلك أن يزجوا بأنفسهم في ميدان الأغراض النفعية للغة ليبحثوا فيها عن كلمات توضع في تراكيب غريبة. وعلى أن مثل هذا العمل يتطلب وقتاً لا حد له لا يتصور التوفيق بينه وبين الغاية النفعية للغة: فإن الكلمات تعتبر آلات تستخدم، وفي الوقت نفسه يجتهد في انتزاع هذه الدلالة منها". قال أبو عبدالرحمن :"لا صامت ولا متكلم" ثالث مرفوع لا يقبله التصور. والمعنى الذي كرر سارتر الحديث عنه ذو ثنائية لم ينتبه لها، فهناك المعنى اللغوي.. والمفردة في القاموس ذات أكثر من معنى، وهي أعم من مراد المتكلم. وهناك المعنى الذي في ذهن المتكلم ويريد أن يعبر عنه.. أي مراد المتكلم، وهو أخص من دلالة القاموس. والالتزام انتماء لموقف عن حرية فكرية يعرف بالسلوك وبالقول، وعرفانه بالقول أن لا يكون ثم تناقض في الأقوال التي تعبر عن المواقف، وأن يكون الموقف مفهوماً من القول.. إذن كل قول مفهوم فهو قابل للالتزام. فالتزام الكاتب- غير فني التعبير- يتم بكلام يعبر فيه عن مراده بسياق يفهم باللغة والنحو والفكر والقرائن بحيث يحدد معاني الكلمات القاموسية العامة. وغرض الكاتب الملتزم أن يعِّرف يمجهول يجهله المخاطب أو يقل تصوره له، فوسيلته الكلمة القاموسية المباشرة أو السياق النحوي المباشر. وقد يكون غرضه أن يبرهن على معروف ويقنع به فيضيف إلى وسيلة اللغة والنحو أداة الفكر والحس والأقيسة.. وهو يحرص على المباشرة وسرعة الإيصال إلى المتلقي. أما الشاعر والناثر الفني الملتزمان فغرضهما التعبير عن المراد الذي يريدان الالتزام له، ولكنه لا يقصد التعبير المباشر وإنما لديه التزامات فنية تحقق جمالاً لتعبيره عن موقفه، ولولاها لاستراح للتعبير المباشر. وأهم عنصر فني الإيحاءُ إيحاءً يحرك المشاعر ويهب القلب طمأنينة وإيماناً بالموقف. وهو بعد ذلك حريص على توسيع جانب الدلالة بالتماسه إيحاءات فوق طاقة المضامين اللغوية المباشرة أو الإيحائية المستهلكة.
|
|
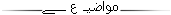
«
الموضوع السابق
|
الموضوع التالي
»
Loading...
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||